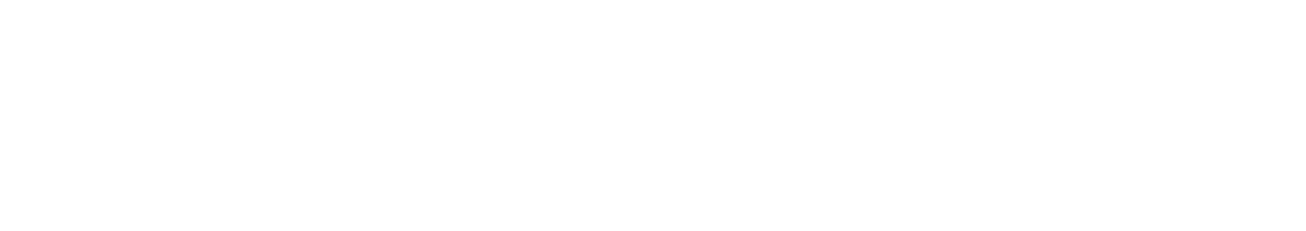في التاسع والعشرين من أغسطس (آب)، عام 1967، أي قبلَ ثلاثةٍ وخمسين عاماً، عُقدت القمة العربية الرابعة في الخرطوم، في أعقاب هزيمة يونيو (حزيران) المنكرةِ ذلك العام، حيث اجتاح الجيش الإسرائيليّ أراضي ثلاث دول عربيةٍ، واحتلّ أجزاء كبيرة منها، بعضها تحرّر لاحقاً في المفاوضات، ونعني سيناء، والأخرى ما زالت محتلةً، بل وأصبحت جزءاً من دولة إسرائيل. كانت أهم نتائج تلك القمة هي ما أصبح يُعرف بلاءات الخرطوم الثلاث: لا صلحٌ، لا اعترافٌ، لا تفاوضٌ مع إسرائيل، مع أنها كانت فرصةً لإنهاء العداء معها، وبدء مفاوضاتٍ تعيد ما احتل، وعلى رأسها مدينة القدسِ القديمة، ولكن لكلّ حادثة ظروفها التاريخية، ولا يمكن إسقاط ظروفِ اليوم على ظروف الأمس. المهم، قوبلت هذه “اللاءات” بابتهاجٍ شديدٍ في الشارع العربيّ، وارتفعت شعارات المقاومة المسلحةِ، ومقولة جمال عبد الناصر إن “ما أُخذ بالقوة لا يستردُ إلا بالقوة”. وفي التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني)، من عام 1977، قام الرئيس المصري الراحلُ أنور السادات بزيارته المفاجئةِ إلى إسرائيل، حيث تحدث في الكنيست الإسرائيلي حول الحقوق المشروعةِ للشعب الفلسطينيّ، ماداً يده بالسلامِ الشامل والكامل مع إسرائيل، منهياً كل أشكالِ الحروبِ معها، ثم بعد ذلك بخمسة وعشرين يوماً، أي الخامسِ عشرَ من ديسمبر (كانون الأول)، عُقد مؤتمر “مينا هاوس”، الذي لم يحضره معظم الدول المدعوّة، وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلةً بياسر عرفات. ووفق ما قاله الرئيس السادات لاحقاً، كان بإمكان الفلسطينيين لو حضروا، أن يستردّوا الضفةَ الغربية وقطاع غزة، وأن يقيموا عليهما دولة فلسطينية مستقلةً، ولكن المنظمةَ كانت انضمت إلى “جبهة الصمود والتصدي”، التي أنشئت بدعوة من الرئيس معمر القذافي، في أعقاب إعلان الساداتِ نيته زيارة إسرائيل في البرلمان المصريّ، وبذلك أضاع الفلسطينيون، ومعهم كل العربِ، فرصةً تاريخيةً لتحقيق أهدافٍ ما كانوا ليحققوها بالوسائل العسكرية. ولكن نرجع ونقول إن لكل حادثةٍ ظروفها التاريخية التي تحكمها، فلا نُسقط ظروف الحاضرِ على الماضي.
ليس المرادُ هنا حقيقةً هو الحديثُ عن تاريخ الصراع العربيّ – الإسرائيليّ، بقدر ما هو استعراض ردّ الفعل العربيّ، الرسمي والشعبيّ، تجاه عملية السلام مع إسرائيل. الرفضُ المطلق كان عنوانَ تلك المرحلة تجاه عملية السلام، حتى أن كل الدول العربيةِ تقريباً قاطعت مصر، ونُقلت جامعة الدول العربية إلى تونس احتجاجاً، وتحوّل السادات إلى رمز “للخيانة”، الرسمية والشعبية، آنذاك، حيث كانت فلسطين هي قضيةُ العرب الأولى، وربما الأخيرة، وفي النهاية “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”. ولكن مع مرور الأيام، بدأت الأحداث تتوالى، والظروفُ المحيطةُ تتغير، وأخرى كثيرةٌ تدخلُ إلى مسرح السياسة العربية والإقليمية والدوليةِ. انهار الاتحاد السوفياتي، وغزا صدام حسين الكويت ثم طُرد منها، وأخيراً سقط هو ونظامه، وكانت أوسلو وما تبعها من تطوّرات فلسطينيةٍ، وصعودُ الإسلام السياسي الشيعيّ بعد الثورة الخمينية في إيران، والتمدّدُ الإيراني من خلال وكلاء في الشام والعراق، وغير ذلك من متغيّرات أدت إلى إعادة ترتيب الأوراقِ في منطقة الشرق الأوسط. ولكن أهم متغيرين قادا إلى نوع من التغيرِ في الذهنية السياسية العربيةِ، هما أفول أيديولوجيا القومية العربيةِ، وصعود ثم سقوطُ الإسلام السياسي السنيِ، القاعدة وما تفرع عنها، بدءاً من حادثة سبتمبر (أيلول) عام 2001.
هذان المتغيران، في ظلّ كل التطورات السابقةِ، أديا إلى نوعٍ من التغير الذهني العربيّ، وإن كان محدوداً في بداياته، تجاه فلسطينَ وقضيتها. ففلسطينُ في المفهوم “القوميّ” العربيّ (الناصرية، البعث، القوميون العراب، اليسار العربي عموماً)، ليست مجردَ رقعة جغرافية معينةٍ، سواء سمّيناها فلسطين أو إسرائيل، يمكن التفاوض حولها سياسياً، بل هي مفهومٌ “ذهنيّ” كان وراء كثيرٍ من الأحداث في عالم العرب. فمنذ عام 1948، عام قيام الدولة الإسرائيلية، كانت فلسطين وقضيتها وتحريرها، هي المبرّر الأول لانقلاباتٍ في مصر وسوريا والعراق، وكانت دائماً تتصدّر “البيان الأول للثورة”، فتتعطّل التنمية، وتُقمع الحريات، وتُسلب الحقوق، وتُقطع العلاقات الدولية، ويستبد الطغاة، من دون أن يتحرّر جزءٌ بسيط من فلسطين الواقعية، بل على العكس من ذلك، كانت إسرائيلُ تزداد قوةً وهيمنةً ورفعة حضاريةً، وتتحوّل من “دويلةِ العصاباتِ الصهيونيةِ”، و”الكيان الصهيونيِ”، إلى دولةٍ وقوة إقليمية مهيمنةٍ وقادرةٍ، في الوقت الذي تنحدر الدول “الثورية” العربيةُ إلى القاعِ الذي تقبع فيه اليوم.
وفلسطينَ في الذهن الدينيّ، هي أيقونة مقدّسة، والعداء مع إسرائيل ليس نزاعاً على أرض، بل هو صراعُ “وجودٍ لا صراع حدودٍ”، صراعٌ دينيّ أزليّ بين المسلمين واليهود، لن ينتهي إلا يوم الدينونة الكبرى، وبالتالي لا محلّ للتفاوض أو حلول الوسط الواقعية في مثل هذا التصوّر، فالنصر مضمون في النهاية، وما علينا إلا الصبر. بسقوط هذين التيارين الأيديولوجيين الكبيرين، بدأت “الواقعية السياسية” تطلّ برأسها على عالم العرب. نعم كان لهذه الواقعية وجودٌ قبل ذلك، مثل أطروحات الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة في الستينيات حول التعامل مع “القضية”، ولكنه كان وجوداً ضئيلاً لا يكاد يذكر، وكانت تهمةُ الخيانة جاهزةً دائماً لإجهاض مثل هذا التوجه. ويُحسب للرئيس أنور السادات أنه كان رائداً في دخول الواقعية السياسية بالنسبة إلى قضية فلسطين حين أخرجها من الوهم الأيديولوجي إلى الواقع السياسي، وحين أعادها من حالة ذهنية إلى حيزٍ جغرافيّ، فقد كان يرى أن العداءَ العربيّ الإسرائيليّ، وعدمَ التعامل مع إسرائيل، أو رفضها بعبارة أدقّ، هو نتيجة “حاجز نفسيّ” تنامى عبر السنين، نتيجة شحنٍ أيديولوجيٍ مستمر، يصوّر إسرائيل على أنها مؤامرة صهيونيةٌ إمبريالية دائمة، ومهما كانت طبيعة الصلح معها، فإنها لن تغير في طبيعتها، ولذا فإن التعامل معها، وبأي شكلٍ من الأشكال، هو نوعٌ من العبث واللاجدوى.
بانحسار المدّ القومويّ العربيّ، والمدّ الأصوليّ الإسلامويّ، بدأت الغشاوة التي كانت تعيق الذهن العربيّ في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، تنزاح شيئاً فشيئاً، وبخاصة في تلك الدول التي كانت توصم بالرجعية، وبشكل أخص في دول الخليج العربية. وقد كان التشرذم الفلسطيني، وصراعُ الأجنحة في القيادات الفلسطينية، وتهافتُ بعض هذه القيادات على مكاسبِ المال والسلطةِ، عاملاً رئيساً في إزالةِ هذه الغشاوة، أو لنقلْ سرّعت في درجة اضمحلالها. لذلك نرى أن الدعوة إلى التعاملِ الواقعيّ مع إسرائيل، بوصفها دولةً قائمةً شئنا أم أبينا، وبوصفها قوةً إقليميةً يمكن التحالف معها في الوقوف أمام الأطماع الإمبراطورية لإيران وتركيا، أي الخطرِ المباشر علينا، لم تعد مرفوضةً تمام الرفض كما كان في السابق، بعد تغلغل “الواقعية السياسية” في الأذهان إلى حد بعيدٍ. بالطبع، وبمناسبة الحديث عن الأطماع الإمبراطورية لإيران وتركيا، سيأتي من يقول وماذا بشأن “أرضكِ يا إسرائيل من النيل إلى الفرات”، أليست هذه أطماعاً إمبراطوريةً أيضاً؟ حقيقةً، فإن هذه خرافةٌ توراتية تعلقنا بها كثيراً، ولكنها لا تعني شيئاً حتى بالنسبة إلى إسرائيل، التي تقوم سياستها على حسابِ أرباحٍ وخسائرَ من زاوية واقعيةٍ، وليس على أساطيرَ دينيةٍ، واليهوديةُ بالنسبة إليها تعبيرٌ عن هوية قوميةٍ وليست إيماناً دينياً، ولكن هذا حديثٌ يطول، وله مجال آخر.
المهمّ في الموضوعِ اليومَ، هو أن الواقعية السياسيةَ في النظر والتعامل مع القضية الفلسطينية والعلاقة مع إسرائيل، قد بدأت تفرض نفسها بشكل أكثرَ جديةً وتأثيراً، وما المبادرةُ الإماراتية الأخيرة في تطبيع العلاقة مع إسرائيل، إلا نموذجاً ومقدمة لما سيكون في المنطقةِ، فقد سئم الناس من تبديد مواردهم، والتضحيةِ بازدهارهم ومستقبل أجيالهم، في سبيلِ أوهامٍ تدور حول القضية، فلا حُلّت القضيةُ، ولا كُسبَ المستقبل، ولا ازدهرتِ الأوطان… هذا، ولله الأمرُ، من قبلُ ومن بعدُ.